|
 عندما كنتُ مشروع إنسان تافه ::
عندما كنتُ مشروع إنسان تافه ::
الكاتب: أ.أحمد الكناني
نشرت على الموقع بتاريخ: 17/11/2004
 هل
يمكن لإنسان أن يكون مشروعا لإنسان آخر؟
هل حقا أن الإنسان آلة تبرمج لتكون هذا أو ذاك؟ هل
يمكن لإنسان أن يكون مشروعا لإنسان آخر؟
هل حقا أن الإنسان آلة تبرمج لتكون هذا أو ذاك؟
حسنا, لسنا بهذه الإستقرائية المادية للإنسان كي نوافق على شيء من هذا, لكنما هناك
ثمة ما هو جدير بالذكر حقا، و هو أننا- بمرحلة
ما من حياتنا- يمكن أن نكون مشاريع لنوع آخر
من أنواع الإنسان.
عليّ أن أخبركم, وبصدق, أنني كنتُ مشروعاً ناجحا لرجل تافه وشديد التفاهة أيضا.
صحيح أنني عشت بالشرق لعامي الخامس عشر, وصحيح أنني تلقيت مجمل آليات ثقافتي العامة
من خلال دراستي بالغرب, لكنما هذا لم يكن السبب المباشر الذي أنقذني من مصير
"الإنسان التافه".
ربما حريا بنا أن
نعرّف الرجل التافه بمجتمعاتنا, ذلك أن هناك أنواع كثيرة من الرجال التافهين-
وكذلك النساء- المتنكرين لكل ما هو متعارف
عليه من إيدلوجيات فكرية محلية, أو منظومات أخلاقية, وليس بالضرورة أن يكون
"الإنسان التافه"
جاهلا, بل لعل العكس هو الأقرب للصحة, إذ يكون
"نصف مثقف"
أو مثقف فعلا, لكن بثقافة تافهة لا تغني هي الأخرى عن الواقعية.
يُقال أن هناك مثقفين تافهين يريدون أن يكونوا ملكيين بأكثر من الملك, كأن يريدون
للعرب أن يعيشوا ديمقراطية هائلة وتسامح عظيم أسوة بالغرب, إلا أن هذا الغرب نفسه
يقود شعوبه بالسوط الاقتصادي وعمليات غسيل الدماغ والترهيب الاجتماعي, ولا يتورع عن
نشر صور فتوحات جنوده وجندياته بسجون المسلمين. ويريدون للعرب التسامح الديني, مع
أن الغرب من يقمع الدين ويضرب مقدسات الآخرين, سواء بالقوانين الفرنسية ضد الحجاب
أو فيلم المتطرف اليميني "جوخ"
المفتري على الإسلام. إذن, كيف يمكن لأحد أن
يكون مشروع إنسان تافه ومتى؟
الواقع أنني نظرت حولي بعيون شرهة, أحاول أن أقفز بالفراغ, أو أن أتشبث بمن أكتب
على ظهره مقالي هذا. كنت قد فكرت بصديقي البقال, أنه شخصية كلاسيكية للغاية لأي شاب
عربي لم يعد يبالي كثيرا بالحياة.
عاش قصة حب يتيم قضت عليه ظروف الاقتصاد والتدخلات العائلية, اعتقل مرارا من قبل
أجهزتنا الرقابية على المنشورات, تحول لمعقد نفسيا-
كما يحلو لي أن أصف التبلد الحياتي-وانتهى لأن
يكون أبا بسيطا لطفلة, يعمل طيلة النهار لتوفير لقمة العيش ويتمنى أن تدك أمريكا
بلاده على ما قدمت له.
إنه "إنسان تافه"
ولا شك, ولقد أخبرته برأيي به دونما نفاق, لكنما ليس بالتفاهة الكافية التي أرجوها,
كما وإنني لا أرغب حقا بأن أوجع آذانكم بقصته الحزينة, ربما لأنني مازلت خائفا
منكم, إذ ترونني أكتب بحذر وبنوع من الدقة الأشبه بدقة من يسير على رؤوس أصابع
قدميه, مخافة أن يوقظ أحدهم. حسنا, لن أكتب عن أحد, سأكتب عني, فأنا-
كما أخبرتكم- كنت مشروع إنسان تافه بحقبة مضت.
بدأت القصة من الصف السادس الابتدائي, كانت الحياة بسيطة للغاية والضوضاء السياسية
تبدو غير مفهومة. أتساءل كثيرا, بطفولتي الحمقاء, عن معنى جبروت
"إسرائيل"
هذه؟ ولمَ لا ندكها بجيوشنا العربية الموحدة؟
آه, و لماذا لا يتحد العرب؟ أسأل المعلّم
العجوز بجدية لا تقبل السخرية, وفعلا, لا يبدو وجهه ساخرا وهو يجيبني لمرة واحدة
وبصدق قد أخافه لاحقا: لأن المجتمع تضافر على قتل أمثالك بالحياة.
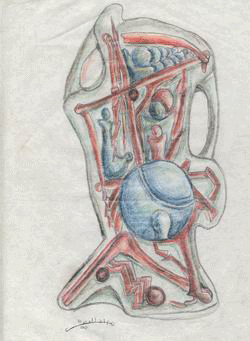
وبالطبع, مرت سنوات طويلة لأفهم أنه كان يقصد أن المجتمع سيحولني لإنسان لوذعي غافل
وغير مبالي... إنسان تافه.
لا أنكر, كانت المرحلة الدراسية آنها حافلة بالنجاحات, ولكن رغم هذا لم أفهم سبب
الاحترام الكبير الذي يكنونه لطالب عراقي آخر (كنا ببلد عربي شقيق) الذي وصل لدرجة
إعطائه امتيازات فخرية بكل فصل؟
وكانت المفاجئة أن والده كان متعهدا غنيا وله أسهم بالمدرسة, لا بل له صلات بحكومة
المحافظة التي تعتبر المدرسة من ممتلكاتها! وماذا يعني- قد تتساءلون- أن يملك كل
هذا؟
لا يعني شيئا لطفل مثلي, لكنه يعنيني للغاية أن تهمل شخصيتي على حساب تلميذ آخر
لأجل أن مهنة والده, وأن أخسر الانتخابات الفصلية لأن أكون "عرِّيف المدرسة" بسبب
حملة المعلمين والمعلمات الدعائية القوية لذاك الطالب. أمور تافهة لا؟
لكنها كانت بداية المشروع التافه أقول لكم, لأن التفاهة لا تنتج سوى التفاهة عادة.
يومها بكيت ظلم الديمقراطية لي, وتعلمت يومها أن أخفف من اهتمامي بفكرة كوني شخصية
لامعة.
يمكن أن تقولوا أن تحيز المعلمين والمعلمات أدى لقتل جانب صغير من الطموح عندي,
ولكنه كان جانبا مهما بالنسبة لقلب صغير هو الآخر.
عند انتقالي للمرحلة الإعدادية, وقد قضيت منها ثلاث سنوات بالمشرق, بدأت مرحلة
الانحطاط كما هي عند كل شاب عربي بهذا السن.
مرحلة من تهافت قيم الطفولة الفاضلة, وبناء قيم الشارع المحلي المنافقة والمدعية
والمتخلّفة. لا أعرف للآن من أين بدأت أتعلم الشتم لأتفه سبب, ومن أين أتت فكرة
"العنترة"
التي تعني أن علي أن أقاتل أي شيء يعترضني وإن كانت بعوضة!
يوما كنا نتحدث عن "البنات", نعم نقولها كمصطلح بعيد عنا: بنات. مخلوقات موجودة
لكنها بعيدة جدا عن واقعنا, لكن ألسنتنا كانت تطولهن وتطول أخبارهن بالمدرسة التي
تبعد عن مدرستنا أربع كيلومترات. هناك حيث يحضر تواجد أي شاب تقريبا, ولم أفكر
بالذهاب قربهن على أية حال. ما هو جدير بالذكر أن هناك طالب يحلو له أن يختم مواضيع
البنات بجملة تقليدية, إذ كان يبصق أولا بحركة جزعة ويقول بلهجة مراهق يتقمص دور
رجل ما: سحقا لجنس حواء كله.
وبمرور الأيام تعلمت أن أرى "جنس حواء" بعيون متحفزة. فكل
"حواء"- حتى لو كانت
"حواءة"
صغيرة رقيقة- هي منحرفة ما لم تتحجب, ويحق لي أن أسمعها أي كلمة أشاء وفق مزاجي.
ورغم أنني لم أقل أي كلمة تحرش لفتيات, لخوفي منهن, إلا أنني كنت أبتسم لمن يقولها
يومها, إذ يبدو لي "قباضاي" وهو مصطلح قد يعني "بطل" مثلا.
وبنفسية غير طموحة ومهمومة بالبطولات والحواءات المزعجات الجميلات على نحو ما, بدأت
أساطير الجنس تتقاذف إلى أذنيّ, ولحسن حظي أنني لم أكن من المعجبين كثيرا بتلك
القصص المقرفة التي ينتشر بها الطابع اللوطي, ولذا لم أسمع أي شيء عن العادة
السرية، ولهذا بقيت بعيدا عنها حتى عامي الثامن عشر. لكني كنت أسمع بعضهم يتفاخر
بعدد المرات ويصف قوته وسرعته بالإنتاج والتوقيت, رغم أنني لم أكن أدري ما يقولونه,
فأنا بدأت رحلة الانطواء يومها.
ومن طرائف الصدف أن غريمي القديم من المرحلة الابتدائية, قد بدء رحلة حبه وتعارفه
على الجنس الآخر مع قريبة له, إذ يخرج معها بصحبة أهله للنزهة, وأنه يحدثها بكل
أريحية, بينما أقف أنا وأمثالي على بعد سنين ضوئية من هذا الواقع.
ومرة أخرى يعود الفضل لوالده الأسطورة الغني, الذي حول حياة ولده لرحلة ممتعة من
التعارف الأخلاقي المهذب على الجنس الآخر, ومن حصد النجاحات. الواقع أنني لم أحسده
ولم أكرهه, بل كنت أنقم على ذاتي الذي وجدتها فقيرة كأسرتي وعفيفة ومترفعة عن ذل
السؤال من أحد. لكني لم أنقم على والدي يوما, لأنه كان يعمل بكل تفاني لأجلنا,
وكانت أسرتنا روحية بكل المعاني الإسلامية, ولم يكن المال مهما لأيٍّ منا.
ورغم هذا لم تكن نجاحات مصطفى تمر دونما الرغبة بأن أعيشها, وكانت الدراسة هي ملاذي
الوحيد لان أكون مثله يوما, لكنني فوجئت أن الدراسة هي سبب آخر للتعاسة, خصوصا أن
"مصطفى" رحل مع عائلته لكندا, بعد أن أكتشف والده أن الدراسة هنا لا تجعل من ولده
سمكريا حتى... مهما كان مجتهدا, وهكذا رحل مع أسرته ولم أعد أهتم لتحدي أحد. بل
لأقل أنني استسلمت للقدر, وأقررت بتفوقه عليّ.
كانت الدراسة نوعا آخر
لتحطيم الذات,
فمن "فلقات" المدرسين إلى سخريات المدرسات وإهاناتهن الغريبة, التي تكون عادة من
طراز: ألا تخجل على شواربك الآخذة بالنمو؟ كيف تنسى كتابة وظيفتك؟ ذات مرّة قررت أن
أبوح بالحقيقة للمدرّسة بالصف الثامن, إذ قلت لها بأنني لا أفهم الدرس حقا, فأجابت
بسخرية: لأنك حمار.
ولا يتردد بعضهن من الصفع أو الضرب بالعصا, الأمر الذي يحدث وجعا أقوى لأن المقابل
أنثى ومن المفترض أن نكون"رجالا" بنظرها, وضربها لنا لا يعني أننا كذلك حقا. هذا
إضافة لتلذذ مدرس التربية العسكرية ببطحنا على الأرض وعلى بطوننا, عندما يزور
المدرسة فريق البنات لكرة الطائرة حيث يأخذ حضرته السانحة
"ليدردش" مع بضع تلميذات
جريئات. وكان بعض الطلاب يسخر منه من مضجعه المهين على الأرض بقوله: أنه يشرح لها
نظرية فيثاغورث.
نضحك يومها لكنني أقول لكم أنني لم أعرف ما هي نظرية فيثاغورث هذي آنها!
رغم أنها كانت ضمن المادة التدريسية, إلا أن المدرّس كان يملأ اللوح بما لا يُفهم
وفق طرق صعبة ومعقدة, وكأنهم لا يريدون أن ينتظروا حتى الجامعة لتعليمنا إياها.
وهكذا تقبلت مع الزمن فكرة أنني "حمار رياضيات" كما أطلق الأستاذ علي أمام الفصل,
رغم أنني سأكتشف بعد سنوات أنني شديد التفوق بالرياضيات والجبر تحديدا. وعلى أية
حال, فقد كنت مجتهدا بالعربية والتأريخ, إلا أن هذا الاجتهاد لم يؤدِّ للكثير, إذ
نجحت بصعوبة إلى الصف التاسع.
خلال السنتين الماضيتين, بالصف السابع والثامن, كنت أزور المكتبة بشكل يومي, ابتداء
من الثالثة ظهرا إلى الخامسة أو السادسة عصرا, وبعدها أمضي للعب كرة القدم لساعة ثم
العودة فالاستحمام, والمضي لعملي الذي يستمر لأربع ساعات يوميا. الدراسة كانت
مهملة, لأنني بصراحة لم أحب المواد المدرسية, وأجد متعتي أكثر بالموسوعات العلمية
والتاريخية والروائع الأدبية, فمن مدارات دموعي خفية وأنا أختتم قصة
"مجدولين"
للمنفلوطي, إلى لحظات دهشة بفن هيغو برائعته "البؤساء".
ولم يكن هناك من يشاركني هذي الاهتمامات ممن أعرف, فكل زملائي بالصف مشغولين
بالتلفاز والمتع الترفيهية والأفكار الجنسية, وهكذا تعلمت أن أسايرهم بما هم فيه,
وكنا نضرب خططا لنزهات العيد بأن أرافقهم للحدائق العامة المزدحمة بالفتيات, مقابل
أن يأتوا معي لزيارة المتحف التأريخي والحربي. لا أنكر أن مشاويرهم كانت مثيرة لي
بسبب وجود العنصر الأنثوي فيها, لكنها كانت بعيدة عني لأنني غير مستعد نفسيا لما
يفعلونه كما كنت قليل الثقة بنفسي وبوسامتي التي كنت أعتقد أنها محرّك الإناث نحو
الذكور.
كنت أشاهد التلفاز كثيرا, وتعلمت متابعة المسلسلات الأمريكية, وبدت أمريكا لي كقبلة
لكل ما هو رائع وأولها الجنس وحلمي بأن أكون طيارا, وليس أي طيار, إنما طيار بسلاح
الطيران الأمريكي تحديدا.
أضحك من نفسي اليوم وأزدري ذاك التافه الذي كنته, ذاك الذي كان يحتقر كل ما هو عربي
لأجل الأمركة, ذاك الذي كان يحلم يوما أن يصادق فتاتا متهتكة أمريكية أو أيا منها,
ليعيش قصة رامبو وصديقاته بالأفلام.
لا تلوموني, فلم يكن هناك من يفهمني أي شيء عن الفكر الإسلامي, كانوا يحتقرون صغر
سني دون أن يعرفوا أنني كنت مستعد يومها لأن أتفهم.
أغلب علماء الدين كانوا مشغولين بتدريس الفقه والتجويد, ورغم أهمية هذا إلا أنني
كنت أطلب أكثر من هذا بكثير.
كنت بحاجة لمن يسمع أفكاري مهما كانت غبية ولمن يوجهني بلطف. ولكن لا حياة لمن
تنادي, فقد كان المجتمع كله محموم بالأمركة وبأفكار الحرية, وكانت هناك فتيات وقحات
شرسات يشاجرن صاحب الملعب الرياضي عن سبب تخصيصه أيام لهن, إذ يطالبن
"بالاختلاط",
ورغم أنني اليوم لا أمانع الاختلاط الصحي, إلا أن ما يطلبنه لم يكن صحيا بالمرة, بل
كنّ متعطشات للرذيلة فقط.
ولليوم لا أرى بالنوادي الرياضية أي أختلاط صحي, لأنني أعتقد أن الاختلاط يجب أن
يكون بالأماكن المعقولة كالمدارس والمشافي والمؤسسات والمطاعم والمسارح, لكن ليس
بأماكن يتمطى بها الإنسان وينحني أو يفتح ساقيه أو يمسح العرق عنه بملابس قليلة.
بعامي الأخير, كنت أرتجف رغبة عندما أفكر أنني سأهاجر لأمريكا, وهاجرت فعلا لأنقطع
بعدها عن أصدقائي الهائمين بأمريكا, ولأواجه واقعا آخر من زنوج يتاجرون بالمخدرات
والنساء, إلى بيض عنصريين متخلفين إلى إباحة واتجار بكل ما يمكن أن يُتاجر به.
فوجئت أن الشعب هنا بائس فكريا, لا يسعى إلا للمال وأن أغلب العرب الذين عاشوا
حياتهم بالمشرق الملوث بالأمركة, يسعون لأن يتأمركوا هنا.
بينما وجدت الأمركة مقرفة بعد حين, وألفيت ساعات قراءتي القديمة بالمكتبة ودروس
الدين البسيطة ذات منفعة هنا, إضافة للتربية التي تلقيتها. وتعلمت أن أحترم المرأة
حتى لو لم تتحجب, وأن أتفهم الآخرين, ولا أنكر جهود
إسلام
أون لاين بالكثير من هذا.
لا أتخيل نفسي اليوم إنسانا بلا مبادئ ثورية ودينية, إنسانا بلا رؤيا للمستقبل أو
طموح علمي واجتماعي وأدبي. يمكن أن أقول أنني أفلتّ من كوني مشروعا لإنسان تافه,
لكن مسببات المشروع مازالت قائمة بشرقنا, وبنسب متفاوتة من مكان لآخر. هناك حيث
تحطيم النفس, حيث السخرية, حيث الجهل, وحيث الجهل بالدين نفسه. سعيد أنا أنني لم
أتحول لمشروع إنسان تافه, وأرجو من الكل أن يسعف نفسه بأساليبي متى ما شعر أنه
سيتحول إلى هذا المصير, أو أنه كذلك فعلا.
فلا ضير من الابتداء بملء الوقت بما هو مهم, والنظرة الواقعية للفكر الغربي
والأمريكي الاستعماري تحديدا.
شكرا للقراءة
|
الكاتب: أ.أحمد الكناني
نشرت على الموقع بتاريخ: 17/11/2004
|
|
