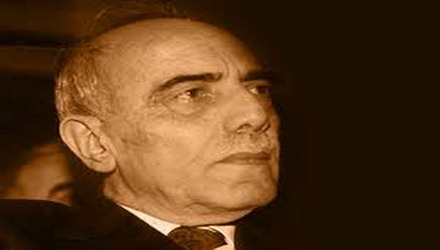حوار مع شاعر فلسطين يوسف الخطيب (1)
* عام 1955 صدر ديوانك الأول ((العيون الظماء للنور)) -الديوان مليء بالأمل الذي تتحدث عنه- كيف تنظر وبعد هذه السنوات إلى هذا الديوان؟؟
** أنظر الآن إلى هذا الديوان بمزيد من الرضى والكفاية والاقتناع، فلقد كان باكورة أعمالي الشعرية، ويشهد الله أنني كلما عدت إليه، غبطت نفسي عليه، وأظن بتواضع أنه كان أكبر من سني الجامعية آنذاك بسنوات وسنوات.
* في ((العيون الظماء للنور)):
أنا مشعل أنا مارج جبار لا الريح تخمدني ولا الإعصار
سأمد في الآفاق ألسنة اللظى حمراً لها في الخافقين أوار
ولأحرقنّ الليل حتى تنجلي أسدافه فتوقدي يا نـــــار
هي الثورة المبكرة، حركة الشعب المثورة، قبل حدوث هذه الحركة.. هل كان يوسف الخطيب الشاعر الذي يرسم طريق شعب فلسطين، وهل كان الشاعر الذي يرفض الاستكانة إلى الحنين السلبي الذي لا يفعل؟؟
** ثمة -غير هذا الشاهد الذي تفضلت به من ديوان ((العيون الظماء للنور))- شواهد أخرى كثيرة تؤكد هذا التوجه ذاته، التوجه إلى استنفار كل خلية من خلايا الجسد الفلسطيني المثخن بالجراح إثر كارثة عام 1948، إلى أن تكون على أهبة الحضور والاستعداد لاستئناف الثورة، تلو الثورة، تلو الثورة، إلى أن يتم لشعبنا العربي الفلسطيني أخيراً تمام الخلاص والتحرير.
هنالك مثلاً قصيدة ((همسة إلى لاجئ)) عام 1953، وهي التي لم يبق مخيم فلسطيني في سوريا، أو الأردن، أو لبنان، إلا أوصلتها إليه نشراً، أو ألقيتها في جموعه الحاشدة مباشرة.... ومن خاتمة أبياتها:
أيها اللاجئ انتفض / أنا أنت.. / أنا للذبح أولاً / ثم أنت / نحن كبشان للفدا / فانتفض../ نحن للموت، للردى / انتفض.. / وإذا أنت لم تثر / فاندثر.. / خذ لكفيك خنجراً / وانتحر/.
وكذلك من قصيدة ((الجحيم المفقود)) عام 1953 أيضاً:ضاع فردوسه، فأين جهنم / في لظاها الجبار يفنى، ويعدم / ليته كان ذرة.. وتحطم / ليته ثار في الوجود لهيباً / من لظى الثأر مارجاً مشبوباً.
وكذلك أيضاً من قصيدة ((موعد الثأر)) عام 1955:
سنلتقي يوماً على موعــد للثأر، في يافا، وفي الكرمل
سيجمع التاريخ أشتاتنا واحدة الراية والجحفــــل
ويعلم الشذاذ من أمتــي أي دار حرة موئلـــــي
وليس أخيراً، مثل هذا الشاهد من قصيدة ((العيد يأتي غداً)) من الديوان الباكورة نفسه:
فيم أعيادنا، وفيم الأهازيـــج وحشد الآلاف حول المنابـــرْ
ما لنا والفخار، والقدس تدعونا فهل حركت حمية ثائــرْ
من دوي الرصاص يغتصب المجد اغتصاباً، لا من دوي الحناجرْ
فهذه الشواهد الخاطفة وأمثالها -لشعراء آخرين عديدين، فلسطينيين وغير فلسطينيين- هي في اعتقادي التي استجنت بذرة الثورة في بطون المخيمات منذ مطالع الخمسينات، وهي بالتالي التي استولدت ((رصاصة)) الثورة الأولى ليلة 1/1/1965، إذ ما دامت الكلمة الحرة حية حاضرة في الوجدان، فمطلب الحرية بدوره هو أسمى غايات الإنسان.
وأما عن شعر ((الحنين السلبي)) في الشق الأخير من سؤالك، فلاشك أن عاطفة ((الحنين)) في ذاتها هي قوة خلاقة، وذات طاقة تفجيرية هائلة في حقل الإبداع الفني والأدبي، وأما أن يكون الحنين سلبياً، بمعنى أن يقتصر على كونه مجرد تأوهات وتوجعات عاطفية خانعة، فذلك في حقيقة الأمر لن يكون في مقدوره أن يعكس فناً أو أدباً حقيقياً، أو أن يثمر بالنتيجة أية إضافة إبداعية جديدة.... وعوضاً عن ذلك، في اعتقادي، فإن هارمونية التوازن النفسي الكامنة بعمق وأصالة حتى في طوية إنساننا العادي، لابد من أن يقابلها الأديب الحقيقي بما يشبعها ويعطيها كفايتها من هارمونية التناسب الفني بين عاطفة الحنين من جهة، وبين معادلها النفسي من الإثارة والاستفزاز والتحريض على فعل الحرية والخلاص.
* كنا على مقاعد الدراسة، وكان يوسف الخطيب معنا في شعره، أحببناه في ((العندليب المهاجر)) وكبرت معنا: لو قشة مما يرف ببيدر البلد خبأتها بين الجناح وخفقة الكبد.. هذا الشعر ومثيله أعطانا الكثير، أرجو أن تقف بالذاكرة عند هذه القصيدة، ثم.. لماذا ابتعد أكثر الشعر الفلسطيني عن هذه الحرارة والعاطفة الرائعتين؟؟
** أظن أن قصيدة ((العندليب المهاجر)) -عام 1955- تمثل بداية نقلة مفصلية رئيسية في نتاجي الشعري لعقد الخمسينات، فبعد مرحلة القصيدة الهائجة الثائرة المجلجلة التي تزامنت في بداية الخمسينات مع طراوة الجرح الفلسطيني الساخن الذي كان ما يزال قريب العهد، وبعد مضي سبع سنوات، في ذلك الحين، على هذا الجرح وهو ما يزال مفتوحاً ودافقاً وفاهقاً دون أن تلوح في أفق الواقع العربي أية بادرة جادة لإسعافه وتضميده، فلقد بدأت أحس شيئاً فشيئاً أنني أدخل في مرحلة القصيدة المتأملة الهادئة، ولكنه ذلك الهدوء الظاهر على السطح فقط، بينما هو يغتلي في باطنه وأغواره العميقة بكل نوازع الرفض والتمرد والعصيان على واقعنا الراكد، وإنما هذه المرة بقدر غير قليل من الجمالية الغنائية الرومانسية، كما لو كانت طوراً مفاجئاً، هادئاً، وحالماً، ومتعمقاً في حقيقة الألم، في إطار البناء الجدلي العام لسيمفونية صاخبة.
ومع أن ((العندليب المهاجر)) هي قصيدتي الأولى التي تمثل هذه النقلة البارزة من طبقة ((الجواب)) إلى طبقة ((القرار)) كما يقول الموسيقيون، فإنها للحقيقة ليست القصيدة الوحيدة من هذا النوع، بل لقد أردفتها بقصائد عديدة أخرى من مثل ((بحيرة الزيتون))، و((أغان من فلسطين))، و((نغم لم يتم))، وهي جميعها لم تكن مجرد انسياحات عاطفية منفعلة، بقدر ما توخيت لها أن تكون شعلاً عاطفية فاعلة ومحرقة في قتام واقعنا العربي الثقيل، الأمر الذي عبرت أنت عنه في منطوق سؤالك بثنائي: الحرارة والعاطفة.
وأما لماذا ابتعد أكثر الشعراء الفلسطينيين -أو دعنا نقل بعضهم على الأقل- عن مثل هذه الحرارة والعاطفة، فلعل من أخطر العوامل التي أدت إلى ذلك هو شهوة بعضهم إلى كتابة أدب ((مؤدلج))، أي في إطار أيديولوجية سياسية مسبقة الصنع خارجياً، وسهلة الاستيراد والاستهلاك على حد سواء، فهي من جهة أولى توفر لهم مكسبين هائلين دون كبير عناء، المكسب الأول أنها تقدم للشاعر ما يشبه العدة الكاملة من منهج أدبي جاهز، وأشكال حداثية معلبة، ومضامين شعرية محددة، وقيم جمالية رائجة، من احتياطي ما يمكن أن ندعوه بحق ((مصرف التسليف الأيديولوجي)) الذي ينتمي إليه، ثم يتبع ذلك بالضرورة المكسب الهام الثاني وهو ضمان انتشار أعماله الشعرية، ورواجها المنقطع النظير، وربما احتمال ترجمتها إلى عدة لغات عالمية أيضاً بقدر اتساع دائرة النفوذ التابعة لتلك الأيديولوجية؛
وأما من الجهة المقابلة فإن الثمن الباهظ والحتمي لكل هذه المكاسب الآنية العابرة هو الوقوع في جميع عيوب المحدودية، والتحنط، والتعصب، والاستعاضة أخيراً عن فضيلة الالتزام الذاتي من أعماق النفس، برذيلة الإلزام والإملاء من مؤثرات العالم الخارجي. ولا شك أن محاولة إشباع هذه المسألة المتعلقة بعيب ((الأدلجة))، ليس بالأمر المستطاع، ولا المطلوب أيضاً، في سياق مثل هذه المقابلة الصحفية المحدودة على أية حال.
* لنقف عند حدود التجربة كاملة، ما زال يوسف الخطيب منحازاً إلى جماهيرية الشعر، يطوّر القصيدة، مع المحافظة على وصولها، ماذا تقول حول ذلك؟؟
** مسألة الإيصال الشعري للجماهير شغلت أناساً لا حصر لهم من المشتغلين في حقل النقد والإبداع طيلة ما يقرب من مائتي سنة حتى الآن، ورغم كل هذا الجهد الكمي الهائل في محاولة فلاحة هذه المسألة فكرياً -وربما بحكم سهولتها المتناهية- فإن حاصل مردودها النوعي لم يكن مقنعاً ولا شافياً، وما يزال غير نهائي، لأن مفهوم ((جماهيرية الفن)) في ذاته أشبه بحقيبة فارغة يتسنى لكل أديب أو ناقد أن يعبئها بأمتعته الفكرية الخاصة، أو أن يعيد تعبئتها مرات ومرات بنسبة اختلاف الزمان والمكان، وبنسبة اختلافه هو كإنسان.
هنالك مثلاً من يصفقون بحرارة بالغة لقصائد مايكوفسكي لأنها كانت تنزل من جماهير الثورة بمنزلة الخطاب المباشر الملتهب المثير، ولكن هنالك أيضاً، من قاعدة الجمهور البشري نفسه، من يتسمر في مقعده أمام شخصية هاملت الفلسفية على مسرح شكسبير، وطبيعي جداً أن المشاهد ((أ)) لشخصية هاملت لن يستقبلها بنفس درجة المشاهد ((ب)) أو المشاهد ((جـ))، ولكن الثلاثة معاً سيتصلون بها على أية حال بهذا القدر أو ذاك من الوعي والإحساس، فعملية ((الإيصال)) من قبل الشاعر أمر مجتزأ ومنقوص، ما لم ندرسها على ضوء مقدرة الآخرين المتلقين على ((الاتصال)).
وهكذا، ففي اعتقادي الشخصي أن أفضل صيغة لجماهيرية الشعر، والفن عموماً، هي تلك التي يستتبع ((إيصالها)) أكبر قدر مستطاع من ((اتصال)) الآخرين بها، بنسب متفاوتة بطبيعة الحال، وهذه الصيغة في الحقيقة هي التي حاولت جاهداً أن أعتمدها في جميع قصائدي وأعمالي الأدبية الأخرى، بحيث لا أستعلي بها مطلقاً على أيما فرد عادي من الناس، وبحيث أطمح بالمقابل أن تحظى بقبول حسن عند الصفوة المختارة من كبار المثقفين، ولست أدري إلى أية درجة قد أفلحت فعلاً في تحقيق مثل هذه المعادلة الصعبة، إلا أنني أعترف بأنها كانت هاجسي الأساسي في كل ما كتبت.
* ((مجنون فلسطين)) ديوانك السمعي ((انطلاقة تأسيسية كاملة لا تستند إلى أية تجارب سابقة)) ما هو السبب في توجهك إلى هذا الجديد المغاير؟؟
** كان هاجسي الكبير طيلة مسيرتي الشعرية المتواضعة، هو أن أحاول التجديد إلى أبعد الحدود، ولكن، على قاعدة التأصيل إلى أعمق الجذور، ومن هنا فإن تجربتي التأسيسية في ديوان ((مجنون فلسطين)) السمعي، بقدر ما تمثل، من أحد وجهيها، انفصالاً شبه كامل عن جميع الطرائق التقليدية في نشر الشعر وإيصاله إلى جمهرة المتلقين، بقدر ما تمثل، من وجهها الآخر، اتصالاً كاملاً أيضاً بتلك الخاصة التراثية الفريدة للشعر العربي، من جهة حضور الشاعر المباشر بين يدي جمهوره، كما كان عليه الحال في المربد وعكاظ، أو على الأقل من جهة حضوره الذاتي هذا بين أفراد قبيلته، أو ترحاله عبر الآفاق البعيدة بسبيل أن ينشد ما قد أبدعته قريحته أمام الأفراد والجماعات على حد سواء؛
وهكذا ظل حال الشعر العربي لمئات الأعوام اللاحقة اقرب إلى طبيعة النفس العربية ((مسموعاً)) أكثر منه ((مقروءاً)) حتى لكأن شاعرنا القديم قد أراد أن يشير إلى هذه الخاصة ذاتها بقوله: ((الأذن تعشق قبل العين أحياناً))، ولذلك أيضاً انتشر الشعر العربي ((بالرواية)) أكثر مما انتشر ((بالتدوين)) حتى في أوج ازدهار الحضارة العربية في أوائل العصر العباسي، وشيوع القراءة والكتابة في جمهرة واسعة من الناس، وظهور ألوف المصنفات النثرية في اللغة، والفقه، والفلسفة، والعلوم، فرغم كل ذلك كان لرواة الشعر -ولنقل الحمادين الثلاثة مثلاً- حضورهم القوي والمؤثر، ولست أدري تماماً ما الذي كان عليه الحال في أشعار الأمم الأخرى، إلا أنني لم أصادف مطلقاً أنه كان لكل شاعر أجنبي ((راويته)) المختص بإيصال قصائده للآخرين، كما هو واقع الحال في شعرنا العربي، وحتى يومنا الراهن إلى حد كبير؛
فلهذا السبب أصدرت ديواني ((مجنون فلسطين)) بالطباعة الالكترونية المسموعة، عوضاً عن طباعته العادية المقروءة، مستفيداً في ذلك من منجزات العصر السمعية -الكاسيت والمسجلة- التي ربما غدت في بعض الأحيان أكثر شعبية وانتشاراً حتى من الكتاب نفسه، ومع أن هذه الطريقة لا تمثل حضوراً كاملاً للشاعر، بلحمه ودمه، بين يدي جمهوره، إلا أنها في جميع الأحوال أكثر حضوراً من الكتاب العادي الذي ستبقى له قيمته الكبيرة بكل تأكيد، ولعلي سأتمكن ذات يوم قريب من تعزيز هذه التجربة واستكمالها، عن طريق النشر المزدوج لبعض الأعمال الجديدة بالطباعتين العادية والالكترونية في نفس الوقت.
ويتبع >>>>>: حوار مع شاعر فلسطين يوسف الخطيب (3)
آخر المقالات
- سلبية الطفل البكر.. من الجاني؟
- حياة زوجية أكثر خصوصية
- اكتئاب الأفراح أو اكتئاب المناسبات الاجتماعية
- أسئلة الأطفال المحرجة.. كيف نجيب عليها؟
- هل تنفع الحروب؟!!
- ألف باء علاقات زوجية
- مدينة أمة!
- حديث عن الصمت الزواجي
- صناعة الأخلاق!!
- زوجة المريض النفسي.. يوميات الهموم والمقاومة
- مغامرات صحفي في عالم السحر
- اعتياد العذاب!!
- الديكور الإسلامي لتزيين منازلنا في رمضان
- العجزُ المُتعَلم!!
- رمضان بين الروح والجسد
- الإبداع والحاجة!!
- المسحراتي.. ظاهرة اجتماعية شعبية
- مَن يحكمنا؟1
- العلاقات الزوجية في رمضان
- الذكاء الاصطناعي التفاعلي!!
حوار مع شاعر فلسطين يوسف الخطيب (2)
المشاهدات 5807 معدل الترشيح 0
تقييم
|
|
لإضافة تعليق يجب تسجيل الدخول أولاً أو الاشتراك إذا كنت غير مشترك