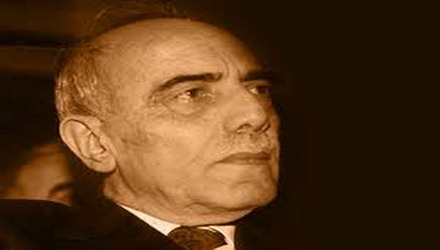حوار مع شاعر فلسطين يوسف الخطيب (2)
* في ((مجنون فلسطين)) قصيدة من العام 1965 وأخرى من العام 1982، هل أردت رصد كل جوانب التجربة الشعرية عندك، أو أن هناك سبباً آخر؟؟
** كلا لم يكن في الوسع إطلاقاً أن أرصد جميع جوانب تجربتي الشعرية في نطاق هذا الديوان، وأما التفاوت الزمني الملحوظ في تواريخ القصائد التي أشرت إليها، فمرده إلى عوامل واعتبارات أخرى، بعضها فني محض، وبعضها الآخر يتعلق بمجرد التبويب والترتيب، ولكن جميع هذه القصائد التي احتواها ((مجنون فلسطين)) هي مما لم يسبق أن نشرته في أي ديوان عادي من قبل، ولعل هذا هو قاسمها المشترك الرئيسي....؛
زد على ذلك أنني قد تعمدت أن أضع القصيدة الأصولية التي يدعونها ((التقليدية)) بموجب الخطأ النقدي الشائع، إلى جانب القصيدة المستحدثة التي يدعونها ((الحرة)) بالمقابل، وأما لماذا فعلت ذلك عن سابق عمد وإصرار، فلاعتقادي الجازم بأن الشاعر العربي، الحقيقي، هو من يجرؤ أن يقف أمام جمهوره متمكناً من جميع أساليب الأداء الشعري، ومسيطراً على جميع أسراره الجمالية، ما كان منها ((أصولياً)) عريقاً ينعش الذاكرة الإنسانية باستعادة فطرتها وطفولتها السحيقة، أو ما كان ((مستحدثاً)) مبتكراً تماماً من شأنه أن يغني النفس وأن يمد بصر الإنسان بعيداً في آفاق المستقبل التي يجهد الشاعر الجاد في استشرافها، وتلوينها، والحداء إليها؛
أما أن يدَّعي شاعر بأنه لا يريد أن يستحدث أيما جديد في دنيا الشعر لأنه ملتزم أمين ((بأصول)) السلف الصالح، أو أن يدعي شاعر آخر، بالمقابل، بأنه يرفض الأصول الفنية الشعرية جملة وتفصيلاً، لأنه قد أخذ على عاتقه أن يلتزم جانب ((الإبداع)) المطلق، دون ما أي ((اتباع)) على الإطلاق، فكل من هذين النمطين من الشعراء إنما يمثل في حقيقة الأمر نصف المهزلة المأساة التي يجتازها حالياً شعرنا العربي المعاصر، إلى حد ما يشبه حالة الإفلاس الشعري بوجه عام، أعتقد بقوة أن الموسيقي العظيم حقاً هو الذي يسيطر دفعة واحدة على جميع مفاتيح النغم، اعتباراً من شبابة الراعي التي يرجع عهدها إلى زمن لا تعيه ذاكرة الإنسان، حتى الاورغ الاليكتروني من أحدث ما أنجزته تكنلوجيا الإنسان، والشاعر بالمقابل، بوصفه موسيقار اللغة، والصور، والأفكار، خليق به أن يحلق إلى الأعالي بجناحين مهيبين في دنيا الشعر، وأن يجمع في آن معاً بين ((ذاكرة الأمس)) و((باصرة الغد)) وإلا، فكل سعيه باطل الأباطيل، وقبض الريح.
* الانتقاء الموسيقي في ((مجنون فلسطين)) من بتهوفن ، إلى تشايكوفسكي، سسبيليوس، ريمسكي كورساكوف إلى برامز، هل كانت القصيدة تفرض النوعية الموسيقية، وسؤال لاحق أيضاً: لماذا أصبحت الموسيقى ترافقك حتى في أمسياتك الشعرية؟!
** لحسن الحظ أن أولى خطواتي الشعرية الجادة في مطلع الخمسينات، قد ترافقت مع تذوق تدريجي لروائع الموسيقى العالمية الخالدة، وشيئاً فشيئاً أخذت أتوغل بعمق في أرجاء هذا العالم الفسيح من الخلق والإبداع الموسيقي، لدرجة أنني اعتبرت الليالي الطويلة التي سلختها مع عمالقة هذا الفن ـ من باخ حتى شوستاكوفتش ـ نوعاً من المطالعة العميقة الجادة، والتحصيل الثقافي الفني الذي أظن أنه لا غنى للشاعر عنه، بقدر حاجته الماسة أيضاً إلى التعامل، أو التواصل، مع جميع الأجناس الفنية الأخرى، من رسم، ونحت، وتشكيل متعدد الصور، لأن جميع هذه القرائح المختلفة تتفجر في الأساس من رأس نبع واحد مشترك.
لذلك كان سهلاً علي ـ بل وسهلاً جداً ـ أن أختار لكل واحد من قصائدي السمعية هذه ما يناسبها من مرافق موسيقي، من كنوز المكتبة الموسيقية العالمية، وطبيعي جداً أنه، لا القصيدة كتبت على مقام السيمفونية، ولا السيمفونية أصلاً بذات صلة مباشرة بما سيكتبه الشعراء لاحقاً عليها، وبرغم كل ذلك فإنني كلما استمعت ثانية إلى ملحمتي الشعرية ((كذابة كل طيور البحر)) مقروءة بمرافقة السيمفونية الخامسة لبيتهوفن انتابني ذلك الشعور المبهم بنوع ما من وحدة النفس البشرية، وبأن ثمة روحاً واحدة تسكن العملين معاً، ربما إلى درجة المطابقة في بعض المقاطع، كأن كلاً من السيمفونية والقصيدة تتصل بالأخرى بسبب قوي.
وأما لماذا أصبحت الموسيقى ترافقني حتى في أمسياتي الشعرية: فحقيقة الأمر أنها كانت تجربتي الوحيدة حتى الآن، في أمسية لاتحاد الكتاب العرب، ولقد سعدت جداً بنجاحها الكبير الذي لم أكن أتوقعه إلى هذا الحد، وإذا كان في الوسع مستقبلاً، أن يقرأ الشاعر أعماله بمرافقة ما يناسبها من الروائع الموسيقية، فلماذا لا يفعل ذلك؟! أوليس جميلاً جداً أن يكون هنالك في كل يوم ما هو جديد؟!، بالنسبة لي شخصياً سأحاول تعزيز هذه التجربة الوحيدة، وترسيخها، المرة تلو الأخرى، وسأسعى جاهداً لتطوير استخدام التقنيات الالكترونية اللازمة لهذه التجربة، لعل أن تصبح تقليداً كامل التأسيس في حياتنا الشعرية المعاصرة.
* بعد الوقت الذي مر على صدور ((مجنون فلسطين)) ماذا يمكن أن تقول هذه التجربة، وهل يمكن أن تتحول الدواوين الشعرية المقروءة إلى مسموعة؟؟
** سيقول لك أي كاتب أو شاعر أو ناشر إطلاقاً، بأن كتابه الأخير لم يكن رابحاً بما فيه الكفاية، وحتى أدولف هتلر نفسه، وقبل أن يتسلم السلطة في الرايخ الثالث، ادعى أمام مصلحة الضرائب بأن كتابه ((كفاحي)) لم يجلب إليه ربحاً يستحق الضريبة، ولكن.... وبرغم هذه الحقيقة المقررة عالمياً، فلابد من كلمة ثقة بيننا، وصدق مع النفس قبل أي اعتبار، وهي أن كاتبنا أو شاعرنا، أو حتى ناشرنا العربي، ربما يعيش أردأ وضع إطلاقاً بالنسبة لنظرائه في الأمم الأخرى، من أقصى أنظمة اليمين، إلى أقصى أنظمة اليسار، حيث يمكن للأديب هناك أن يتحرر بشكل ناجع من ضغوط جميع احتياجاته المادية، ليستطيع أن يتفرغ، بذهن صاف، وبنفس مطمئنة، إلى عطائه المبدع الخلاق... فمثلاً، لماذا يطبع الروائي الأميركي، أو السوفييتي، أو الاوروبي الناجح، قرابة نصف مليون نسخة (تتم ترجمتها عملياً إلى دخل وفير) بينما لا يتأتى لألمع الروائيين العرب، إلا نادراً، أن يطبع أكثر من خمسة آلاف نسخة، مع أن تعداد سكان الوطن العربي لا يقل كثيراً عن تعداد أي واحد من المجتمعات الثلاثة الآنفة الذكر!!..
ومثلاً أيضاً، لماذا يطوف الكتاب الأجنبي الناجح أرجاء الكرة الأرضية، ويترجم إلى أكثر من لغة عالمية، بينما الكتاب المغربي أو المشرقي العربي، لا يطأ أحدهما أرض الآخر المحظورة عليه تقريباً، أو حتى الكتاب الجزائري، على نطاق ضيق، لا يخترق الحدود المراكشية مثلاً الا بما يشبه عملية التهريب!!، واقعنا العربي التعيس هذا يجيب على جميع الأسئلة المتعلقة بانتشار أي كتاب، وما يتصل بتجربة أي جديد من فشل أو نجاح، ومن ضمن ذلك تجربة ((مجنون فلسطين)) التي أستطيع أن ألخصها لك على النحو التالي: نجاح ممتاز فعلاً من جانب المردود الأدبي والمعنوي، وخسارة فاجعة حقاً من جانب المردود المادي.
وبما أنه ليس بالمردود المعنوي وحده يحيا الإنسان، أو ينجح الكتاب، فإن من السابق لأوانه الآن أن أجيبك بدقة عن مستقبل ((الكتاب السمعي)) ناهيك عن أن يتحول الديوان المقروء إلى ديوان مسموع، علماً بأنه ليس فضلاً لأحدهما أن يقضي على الآخر من أجل أن يحل محله، كل ما في الأمر أننا أمام تجربة جديدة تماماً، ولن يجاب على فشلها أو نجاحها إلا بعد انقضاء زمن كاف، ربما إلى أن يتبين المسؤولون العرب كافة، والجمهور العربي نفسه، ما الذي كان يرمي إليه أولئك الأجانب من اختراعهم لشريط ((الكاسيت)) ومسجلة الترانزستور المتنقلة إلى كل مكان... هل من أجل سرقة أغاني المطربين التافهين في معظمهم، والصراخ بسماجاتهم الغنائية من على أرصفة الشوارع، أم من أجل هدف ثقافي وفني وحضاري مختلف كل الاختلاف، في بعض بلدان أوربا مثلاً لا يكتفي القانون بإيقاع أشد العقوبات على أية سرقة فنية أو أدبية، بل إن ((الكاسيت)) الفارغ نفسه يمنع بيعه أساساً إلا لمن يملك ترخيصاً قانونياً بممارسة النشر السمعي.
وفي أوروبا أيضاً قد يستعمل بعضهم الكاسيت ـ بصورة قانونية طبعاً ـ لبعض أغاني الديسكو وصرعات المراهقين، ولكن استعماله الأعم والأغلب يأتي في مجال الفن والفكر والعلوم، وثمة أمامي الآن فهرس كامل لإحدى دور النشر البريطانية يتضمن مئات الكاسيتات الصادرة بمختلف أعمال شكسبير، وميلتون، وشيلي، وكيتس، وإليوت، تحت باب الشعر، وهيغل، وماركس، وانجلز، تحت باب الفلسفة.... وغيرهم وغيرهم في الرواية، والتاريخ، والاقتصاد، وحتى الرياضة، وسائر فروع المعرفة الأخرى... بمعنى مختصر ومفيد، وهو أن ((الكاسيت)) قد اخترع ليكون أداة اتصال جماهيرية تتكامل مع الكتاب العادي وتوازيه وبسعر موحد يقارب التسعين ليرة سورية للكاسيت الواحد ذي الستين دقيقة.
ليس معنى ذلك قطعاً أنني قد رفعت الراية البيضاء مستسلماً أمام خسارتي المادية في ديوان ((مجنون فلسطين)) بل لقد ازددت حماسة لمواصلة التجربة بكل ما تستحقه من تضحية وإرهاق، وإذ نحن نتحاور في هذا الموضوع الآن، فلقد قطعت شوطاً لا بأس به في التخطيط لإحياء تراثنا الشعري العربي الحافل والهائل عن طريق إصدار نماذج مختارة منه في مجلدات سمعية متعاقبة، بل لقد فرغت عملياً من إعداد ((ديوان الحماسة)) بأكمله، لأبي تمام، ولم يبقَ عليّ إلا توفير الإمكانيات المادية اللازمة لتسجيله وطباعته الالكترونية في أستوديو ((دار فلسطين)) رغم تواضعه النسبي، إذ على الأقل قد يساعد مثل هذا النشر السمعي لتراثنا الشعري على ألا تستمع لابنك العائد لتوه من المدرسة وهو يقرأ لك القصيدة العربية بما يشبه السنسكريتية!!.
* في رأي يوسف الخطيب إلى أين وصل الشعر الفلسطيني ؟؟ ثم ماذا تقول عن خصوصية الأدب الفلسطيني؟؟
** نعم، أنا شاعر فلسطيني شديد الاعتزاز بهذه الصفة القطرية النضالية في نطاق الرابطة القومية المكينة، ولكنني مع ذلك لم أعلم، حتى الآن، أن هناك شعراً فلسطينياً، أو أدباً فلسطينياً، كل ما أعلمه أن هنالك أدباً عربياً وحسب، رغم ما درجت عليه أقلام كبار النقاد الأدبيين خلال الجيل المنصرم فقط من تجزئة هذا الأدب الواحد إلى آداب قطرية متعددة، فأصبحت تسمع مثلاً بالشعر العراقي، أو السوري، أو المغربي، وقد لا يستبعد غداً أن نسمع أيضاً بالشعر الصومالي، أو الموريتاني، وهذا كله مجرد خطأ اصطلاحي فادح الخطورة مما أشاعه النقاد والناشرون في حياتنا الثقافية المعاصرة.
بالمعنى القطري الوطني الجغرافي، لا وجود لشيء يدعى الشعر أو الأدب الفلسطيني. أما إذا فسرنا مصطلح ((الشعر الفلسطيني)) على أساس ما يتعلق بالمأساة الفلسطينية، وبالهم الفلسطيني الكبير من نتاج شعري ـ وكذلك الأمر بالنسبة ((للأدب الفلسطيني)) بصورة أشمل ـ فعندئذ لن تقتصر هذه الصفة على الشعراء والأدباء الفلسطينيين بموجب الهوية القطرية، أو ما يعرف بالجنسية السياسية، بل سيندرج تحت هذه الصفة شعراء عرب آخرون، بقدر ما يمكن أن نستثني منها أعمالاً شعرية كثيرة لشعراء فلسطينيين بمجرد الهوية، فمعظم قصائد بعض الشعراء الفلسطينيين في السنوات العشر الأخيرة، سواء داخل الوطن المحتل أو خارجه، لا يمكن اعتبارها ((شعراً فلسطينياً)) بهذا المفهوم الموضوعي، ما دامت قد سقطت في عيب التأدلج، أو التمذهب السياسي، بعيداً جداً عن الطبيعة التحريرية الوطنية للقضية الفلسطينية... فإلى أين وصل الشعر الفلسطيني، بمعنى الفلسطيني الموضوع؟؟.
أعتقد للأسف الشديد أنه انتكس لدى الكثيرين ـ ولا أقول لدى الجميع ـ خطوات عديدة إلى الوراء، عما كان عليه في مده الشامل، وفي موقعه الريادي القيادي، في عقد الخمسينات، وعقد الستينات، وهذا أمر محزن للغاية، ولا يمكن التبرير له من جهة نظر نقدية سليمة بأنه قد جاء انعكاساً حتمياً لوقائع ومجريات ساحة العمل الفلسطيني التي أخذت في التراجع الحاد منذ منتصف السبعينات حتى وقتنا الراهن، ذلك بأن الشعر بخاصة، أو الأدب بوجه عام، ليس من شأنه ولا من طبيعة دوره الريادي الاستطلاعي أن يكون مجرد انعكاس لا بما واقع سياسي أو اجتماعي أو عسكري على الإطلاق، بل هو القوة المحركة والدافعة لتثوير مثل ذلك الواقع، وتنويره، بسبيل خلق واقع جديد.
* أخيراً ماذا يقول شاعر فلسطين يوسف الخطيب للشعراء الفلسطينيين الشباب؟؟
** ما يمكن أن يقال في هذا المجال كثير، على أن الأكثر أهمية هو أن تجد في مثل هذه الأيام من يمكن أن يصغي إليك من شعرائنا الشبان، إن الواحد منهم ما يكاد يحس بموهبته الشعرية في الثامنة صباحاً، حتى يميل إلى الاعتقاد بأنه قد اكتمل شعرياً في الثامنة والنصف، مع أنك كي تصقل موهبة شعرية رائعة، أو أصيلة، ولا شك فيها، فلابد لك من ألوف الليالي من السهر والعذاب والحمى حتى تغني مثل هذه الموهبة باكتساب ثقافي ومعرفي هائل لابد منه، بل لعل الشاعر الحقيقي، كما أتصوره، هو الذي يفارق الدنيا وما يزال في نفسه شيء من التوق.. وأما هؤلاء الذين يولدون شعراء كاملين، فالمعنى الوحيد لذلك هو أنهم قد اختاروا بأنفسهم أن يولدوا ميتين، لأن الشيء الأوحد المرادف للكمال هو النهاية، والنهاية بالتالي هي الموت.
أود أن أقول لهؤلاء الشعراء الشباب أيضاً بألا يهدروا أي جزء من طاقاتهم الإبداعية المتصفة بالعنف والاندفاع كأمر طبيعي في مجال ما يعرف عادة ((بصراع الأجيال)) فالأجيال الأدبية والفنية في آداب الشعوب المتقدمة، وحتى في تراثنا العربي العظيم، هي أجيال تواصل، وتفاعل، وتكامل، يأخذ فيها الشاب كفايته من حكمة الشيخ، بقدر ما يقبس الشيخ بدوره من جذوة الشباب الملتهبة التي تجدد في خلاياه طاقة التعمير الإبداعي المديد.
ولعل آخر ما أود أن أقوله لشعرائنا الشباب كافة، من فلسطينيين وغير فلسطينيين، بأن فاجعتنا القومية هذه وإن تكن محدودة بحجم الرقعة الجغرافية الفلسطينية الضامرة، فإنها تخيم بقتامها الشديد على سماء الوطن العربي كله من المحيط إلى الخليج. وفي اعتقادي أن مثل هذا التحدي المصيري الشامل لأمة بأسرها، لخليق به حقاً أن يستولد في نفوس شبابنا استجابة معادلة له في العنف والشمول، سواء على مستوى الكفاح المسلح بحد السيف، أو على مستوى التثوير والتنوير بشعلة الحرف، حيث يمكن لملف هذا الصراع المحتدم منذ قرابة قرن من الزمان، أن يرفدنا بمصادر وحي وإلهام لأن نكتب أدباً عالمياً خالداً لعدة قرون قادمة.... فما على شبابنا الأدباء غير أن يدخلوا التجربة، لا أقول من بابها الواسع، أعني بذلك باب الصعوبة، والمعاناة، والشعور بكامل المسؤولية في محاولة تذليل المستحيل.
آخر المقالات
- حياة زوجية أكثر خصوصية
- اكتئاب الأفراح أو اكتئاب المناسبات الاجتماعية
- أسئلة الأطفال المحرجة.. كيف نجيب عليها؟
- هل تنفع الحروب؟!!
- ألف باء علاقات زوجية
- مدينة أمة!
- حديث عن الصمت الزواجي
- صناعة الأخلاق!!
- زوجة المريض النفسي.. يوميات الهموم والمقاومة
- مغامرات صحفي في عالم السحر
- اعتياد العذاب!!
- الديكور الإسلامي لتزيين منازلنا في رمضان
- العجزُ المُتعَلم!!
- رمضان بين الروح والجسد
- الإبداع والحاجة!!
- المسحراتي.. ظاهرة اجتماعية شعبية
- مَن يحكمنا؟1
- العلاقات الزوجية في رمضان
- الذكاء الاصطناعي التفاعلي!!
- نظرية المسيح
حوار مع شاعر فلسطين يوسف الخطيب (3)
المشاهدات 4394 معدل الترشيح 0
تقييم
|
|
لإضافة تعليق يجب تسجيل الدخول أولاً أو الاشتراك إذا كنت غير مشترك