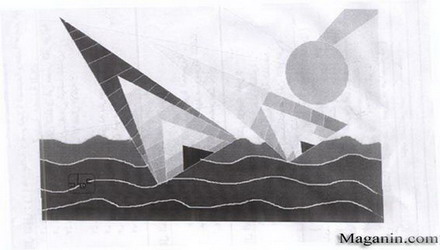-1-
انتهى حفل افتتاح هذا المشروع الضخم الذي تم تنفيذه بنجاح أشاد به السادة الحضور من المسؤولين والوفود الأجنبية. ركبت سيارتي، شرعت في قطع طريق كورنيش النيل مروراً بميدان التحرير، في طريقي إلى مدينة نصر حيث أسكن، انتابني شعور بالتعب والإرهاق، تزايدت معه رغبتي في النوم لقرنين من الزمان، لكن تذكري لنجاح المشروع، رفع عن كاهلي التعب.
رغم أن الإحباط لم يفارقني، لكون مجهودي ذهب كالعادة إلى مديري الذي نلقبه ب"المحظوظ"، لكني لا أرى الأمر حظاً، بقدر أنه تخلف إداري ومحسوبية نعاني منها في أيامنا تلك، لم يفلح معها كوني من أسرة ذات نفوذ وعلاقات قوية، فدائماً هناك من هو أقوى منك!. أنقذتني الطبيعة من هذا الشعور، وكانت بي حفية، تألق النيل وقت الأصيل يرسل النسيم العليل ليداعب وجهي، يحرك أوراق الأشجار لتتراقص فرحاً. ازدادت لدي الرغبة في الاستمتاع بهذه الروعة التي لا تجدها في أي مكان آخر في الدنيا، وأين تجد نهراً كنهر النيل، يشبه في صفاته أنهار الجنة؟ قدت بسرعة متوسطة، إلى أن وصلت إلى ميدان التحرير.
أخذت أدور من الميدان، أوقفتني إشارة ضوئية لتنظيم المرور، كنت أرقب كوبري السادس من أكتوبر لأرى إن كان يعاني من اختناقات مرورية أم لا، حينها واتتني فكرة شراء هدية لزوجتي، فقد تغيبت عنها لمدة ليست بالقصيرة، لم أعلمها بانتهاء العمل في المشروع وحصولي على عطلة، لأعد لها مفاجأة، أعرف متجراً تحب زوجتي الشراء منه كثيراً، عزمت أن أكمل دورتي، لأتوجه إليه.
أكملت الدورة مع الميدان، أخذت أمد رأسي ناظراً ناحية اليمين محاولاً الانضمام إلى السيارات القادمة من تلك الجهة، اعتمدت على الزحام الشديد المعتاد في الميدان، ليساعدني على الانضمام بانسيابية إلى الطريق.
يحتاج الأمر إلى عملية جراحية معقدة، يجب أن أقحم مقدمة السيارة رويداً رويداً، حتى أحتل مكاني في الطريق، تسمى هذه العملية ب"البوز بيز" أو قاعدة "فن احتلال الطريق" بواسطة مقدمة السيارة. تحتاج هذه القاعدة إلى الكثير من التمرس والتركيز، حيث تشتمل على كل قواعد علم النفس والاجتماع، وهي اختراع مصري مئة بالمئة. تمكن المصريون عبر الزمن من إتقان هذه العملية، وتطوير قدراتهم على استقراء الشخصيات، وتوقع ردود أفعالهم. فمثلاً، إذا كان السائق المنافس سائحاً من دول الغرب، فسيظل باقياً في مكانه إلى يوم أن يبعث، أما إذا كان مصرياً يبدو على سيماه الاحترام أو أنه غريباً عن القاهرة فهذا لقمة سائغة، لكن إذا كان سائقاً لسيارة أجرة أو شاباً من شباب هذا الجيل فالعملية أصعب بكثير، وهنا ينتصر من يملك المستوى الأعلى من الجرأة والتحكم في الأعصاب. لم أحب وصف بعض أصدقائي لهذه العملية بأنها عدم لباقة وقلة ذوق، فهي تمتاز بالكثير من المتعة والإثارة وتزيد من قوة الشخصية.
نتيجة لتركيزي الشديد، لم أنتبه لشرطي المرور الذي كان يشير لأتوقف إلا عندما طرق زجاج سيارتي بشدة، أصابني إحباط شديد، حيث أن عدة سنتيمترات خالية قد ظهرت في الطريق، كانت تكفيني لاحتلال مكاني.
فتحت زجاج النافذة، نظرت إليه متأملاً، وجهه أبيض مستدير مثل البطيخة، يحمل شارباً كبيراً وعينين ضيقيتن، وربما يكون حجم أنفه الكبير هو الباعث على الشعور بضيق عينيه هكذا، يرتدي بذلة بيضاء- لا تمت بصلة إلى هذا اللون الناصع-، يقع حزامه أسفل كرشه المنتفخ، وهذه صفة مميزة لنا نحن المصريون حيث أننا نحمل لقب أكبر دولة يملك رجالها كروشاً في العالم، ولم أتبين إذا كان يحمل النصف الآخر من ختم النسر المميز لجميع التعاملات الرسمية في مصر، وأعني بذلك صلعته، حيث حالت قبعته دون الكشف عن حقيقة وجودها.
هززت رأسي في استنكار كأني أسأله عن سر إزعاجه لي، ارتسمت على وجهه ابتسامة من وجد سائحاً ساذجاً -كما نظنهم دائماً في مصر- ليبيعه تمثال أبا الهول، توقعت أنه سيقول لي، "سفنكس يا خواجة"، لكنه قال:
- لقد كسرت الإشارة يا أستاذ.
ارتسمت على وجهي علامات التعجب، نظرت عبر زجاج السيارة الأمامي، فلم أجد أعمدة أو إشارات! أشرت بكلتا يديي وأنا أقول معترضاً:
- أي إشارة؟ أين هي؟.
أشار بكل هدوء نحو مكان على الأرض خارج نطاق رؤيتي:
- هذه الإشارة يا محترم.
نزعت حزام الأمان، خرجت بنصف جسمي من النافذة لأنظر حيث يشير، لم أرَ شيئاً، حدثته بلهجة صارخة:
- أي إشارة تلك؟.
- ارجع قليلاً إلى الوراء وسوف تراها يا محترم!.
أرجعت السيارة إلى الخلف، ترجلت منها غاضباً لأرى تلك الإشارة، وجدت ما يشبه أثراً مشوشاً لما كان يمكن أن يسمى بطلاء منذ عدة عقود، التفت نحو الشرطي غاضباً:
- ما هذا؟ هل كان هناك مسابقة لعب بالطباشير للأطفال؟.
- لا يا أستاذ، أنا لا أسمح لك، هذه إشارة عمرها من عمر الميدان، ولا أسمح لك أن تستهزئ بها، هذه إشارة الخديوي إسماعيل.
لم أستوعب عما يتحدث، رددت متسائلاً:
- خديوي، من؟
أجاب متباهيا بمعلوماته التاريخية العظيمة:
- الخديوي إسماعيل، من بنى هذا الميدان.
- يا أخ، هل كانت السيارات في زمن هذا الخديوي، تحتاج إلى إشارات مرورية؟.
- ليس عندي وقت يا أستاذ، نحرر مخالفة أم نقول كل سنة وأنت طيب؟.
عرفت ما يرمي إليه، لكني لست من هذا النوع. أعلم أنه شرطي مسكين يستحق المساعدة، فما هو إلا أحد أبناء النجوع والأقاليم البسطاء، لم يكمل تعليمه في غالب الظن. لكن لا يمكن أن أساعده على فعلته أبداً، قلت وأنا أستدير مبتعداً:
- كل سنة وأنت طيب.
كرر السؤال بصوت غاضب، التفت نحوه وأخبرته أني لن أدفع رشوة أبداً، وأن هذا مخالف للدين والأخلاق والقوانين. بدت عليه علامات الاضطراب، يبدو أنه لم يقابل أحداً ألقى عليه مثل هذه المحاضرة الأخلاقية من قبل.
أخذ ينظر حوله كمن يستغيث، اقترب منا أمين شرطة، وجهه أشبه بخيارة، رسم عليها شارب رفيع، يكاد زيه أن يسقط من فوق جسده النحيل، ارتسمت على وجهه ابتسامة بلهاء، وهو يسأل رفيقه:
- ما المشكلة يا خضر؟.
بكل براءة:
- لا شيء، الأستاذ كسر إشارة الخديوي إسماعيل، ولا يريد أن أحرر له مخالفة!.
ازدادت ابتسامة هذه الخيارة التي نبت من أطرافها إنسان، أمسك يدي وانتحى بي جانباً، قام بدور من يخلّصني من ورطة كبيرة:
- يا أستاذ، لا داعي لتحرير مخالفات، خصوصاً بعد تطبيق القانون الجديد.
يبدو أن المشروع الذي انشغلت به في الفترة الماضية قطعني عن الحياة تماماً. بدت على وجهي علامات التعجب، التي قرأها السيد خيارة، استرسل قائلاً في همس كمن يفضي لي بأسرار حربية:
- وقد تم تشديد الغرامات وتغليظ العقوبات؛ مخالفة مثل كسر هذه الإشارة قد تدفع فيها آلاف الجنيهات، وقد تحبس أيضاً لمدة عام أو اثنين!.
غمز بعينه قائلاً:
- وكل سنة وأنت طيب.
أذهلني ما قاله، لكن من عادتي أني لا أرضخ بسهولة، هذه خبرة اكتسبتها من الزواج، صرخت فيه:
- وهل تسمى هذه إشارة؟.
شعر أنه لا رجاء مني، غمز رفيقه ليحرر لي مخالفة، فانطلق خضر ينفذ الأمر فطلب مني رخصة القيادة وأوراق ملكية السيارة، ليحرر المخالفة، كدت أصرخ مهدداً بأني وأني...... لكن قاطعنا قائد السيارة التي تقف إلى جوارنا منذ مدة ولم ننتبه لوجودها. يقودها رجل ريفي سمين يبدو عليه أثر النعمة، ذو كرش عظيم، وجهه ممتلئ، يعلوه شارب كبير، يرتدي جلباباً تعلوه عباءة سوداء، تكسو رأسه عمامة منسقة، كان محشوراً خلف عجلة قيادة سيارته الفارهة وتجلس زوجته في الكرسي المجاور، ترتدي جلباباً أسوداً وطرحة سوداء والكثير من المصوغات الذهبية. خرج برأسه من نافذة السيارة وأشار إلي لأقترب منه، تركت خضر منتظراً بكرشه وبذلته التي فقدت لونها الأبيض، انحنيت نحو السائق الريفي، سألني:
- لو سمحت يا أستاذ، من أين يذهبون إلي الملاهي المائية؟
نظرت داخل السيارة لعلّي أجد أحفاده، فربما جاء لينزههم، لكني لم أجد أحداً! كدت أنفجر في وجهه صارخاً فهذا ليس وقتاً مناسباً، لكني وجدتها فرصة سانحة لتجاهل خضر، الذي لم يتركنا في حالنا، ودفعه الفضول ليقترب منا، وما أن مرت ثوانٍ معدودة، حتى اشترك معنا في الحوار، وقاطعني ليقوم بوصف الطريق ل"حضرة العمدة"، على حد تعبيره!. تطلبت العملية جهداً جهيداً، ليس لغباء حضرة العمدة لا سمح الله، ولا لقصور في وصف خضر، الذي لم يبخل بشرح أدق التفاصيل، حتى أنه لم يترك مطباً أو حفرة، قد تساعد حضرة العمدة في بلوغ هدفه دون أن يأتي على ذكرها! لكن المشكلة تكمن في أن الطرق في مصر مثلها مثل جحر كبير، تسكنه الثعابين الضخمة فارهة الطول، التي لا تعرف لها أول من آخر، لمن ينتمي هذا الذيل؟ أو لمن تنتمي هذه الرأس؟ لا توجد علامات إرشادية تهديك السبيل، في معظم الأحوال لا تملك إلا أن تردد النشيد الوطني للتائهين "المحلة منين، يا سمنودي؟"
بينما نقوم بعملية الشرح هذه، قاطعتنا آلة تنبيه ارتفع صوتها بشدة، أطلقها شخص نفد صبره، جاري تشحيم وتزييت الجزء التالي، يرجى الانتظار...
(1) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رفعت إلى السدرة ، فإذ بأربعة أنهر: نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران: النيل والفرات"
- جزء من حديث صحيح.
الراوي: أنس بن مالك، المحدث: البخاري، المصدر: الجامع الصحيح. الصفحة أو الرقم: 5610.
بقلم: عدنان القماش.
29 يوليو 2008.
المنصورة، جمهورية مصر العربية.
تنبية هام: جميع الشخصيات والهيئات والأحداث والمركبات من وحي خيال الكاتب. ولا تمت بصلة من قريب أو بعيد لشخص أو هيئة أو مكان أو مركبة. ولو وجدت علاقة، فهي على سبيل الصدفة المحضة.
آخر المقالات
- محمد بن سيرين مُفسر الأحلام!!
- يمكن... زعلان من زوجته!
- فقهاء الكراسي والمآسي!!
- وساوس المعاملات الحسد والعين RCBT الوسواس القهري الديني32
- المفقودية الفاعلة فينا!!
- أطفالنا.. تلك المرآة التي لا تكذب!
- !!الطبع!!
- تلك الأيام التي خذلتنا.... وأنقذتنا!
- الوظائف والمخاوف!!
- قلوب.. تهرب ببطء!
- الدول الفاشلة والبشر!!
- الذين يكرهون أنفسهم!
- اللا مفهوم مذموم!!
- الحنين.... إلى الغموض!
- معارضات وتناحرات!!
- الشهامة... في غير وقتها!
- مدينة أمة !!
- صورتي الجديدة!
- البشر ومتلازمة الكرسي!!
- الملحد... قراءة نقدية نفسية
بيب بيب
واقرأ أيضا:
المشاهدات 4024 معدل الترشيح 0
تقييم
|
|
لإضافة تعليق يجب تسجيل الدخول أولاً أو الاشتراك إذا كنت غير مشترك